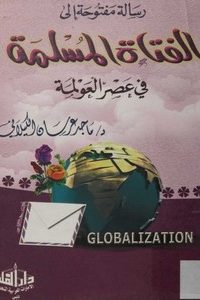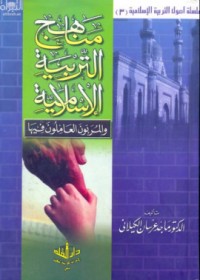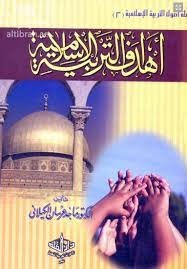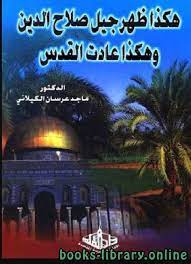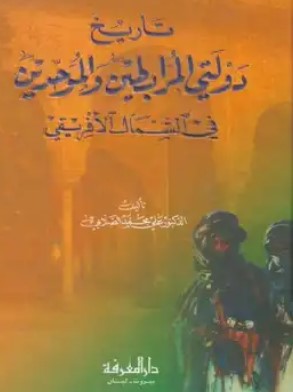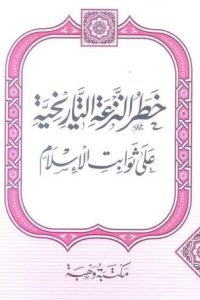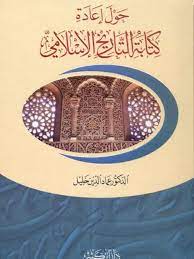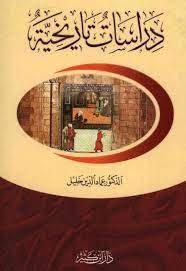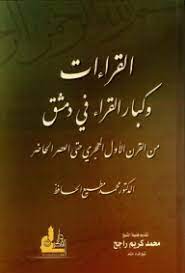تحميل وقراءة كتاب فلسفة التاريخ الإسلامي pdf مجاناً

وصف الكتاب
منذ زمن-غير قليل- وأصوات المخلصين من المختصين والدّارسين للتّاريخ الإسلامي تتداعى لكتابة هذا التّاريخ، لأنّه تاريخ لمّا يكتب بعد، وإنّ الكتب التي تملأ خزآئنه لا تمثّله, يستوي في ذلك ما كتبه المؤرخون القدامى من المسلمين أنفسهم، وما كتبه الآخرون خاصة المؤرخين من أوروبا وأمريكا الذين يكتبون هذا التّاريخ بروح عدائية هدفها تشويهه، وحقن النّاشئة به ليصبح معوقاً بدل أن يكون حافزاً، وأمّا مؤرخو المسلمين القدامى فإنّ منهاجهم في كتابة التاريخ كان متأثراً بالعصبيات التي كانت قائمة آنذاك.
وهذا البحث يضم صوته إلى هؤلاء وأولئك، فيقول: إنّ التّاريخ الإسلامي لم يكتب بعد لسببين هما:
الأول: إنّ الأسفار والمخطوطات المكدّسة في رفوف المكتبات تحت عنوان “التّاريخ الإسلامي” هي أكوام من الوقائع والحوادث التي حدثت خلال مسار هذا التاريخ دون منهاج ينتظمها، وتمّ تكديسها على الأوراق دون تصنيف أو تحييزها في حيّز معين دون أهداف توجهها.
والسبب الثّاني: إنّ كلّ بحث في التّاريخ الإسلامي لابدّ أن يسبقه وعي تام وإحاطة كاملة بفلسفة هذا التاريخ التي غذّت نشاطاته ووجّهت مسيرته وخططت استراتيجياته، وفقدان هذه الفلسفة فتح الباب- وما زال مفتوحاً – ليكتب هذا التّاريخ في مسارات الاغتراب، وفي ضوء فلسفات انتحلها ذووها من أهوائهم العرقية وانتماءاتهم العصبية، ولذاك جاءت هذه الكتابات غير علمية ولا موضوعية لأنّها خالفت أبسط قواعد التّاريخ ومناهج البحث التاريخي التي تشترط استنباط فلسفة تاريخ أي مجتمع من العقيدة التي قام عليها، وشكلت منجزاته، وغذّت تطبيقاته، ومنحتها سماتها المميّزة في ميادين النّشاط المختلفة، وهي “في الغالب” كتابات عمياء لا تبصر الحقائق الكونية التي تخبرنا أنّ سوابق العزائم لا تخرق أسوار السنن الإلهية التي توجّه وقائع التّاريخ وتحدد مساراته.