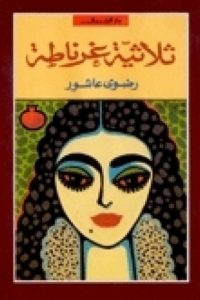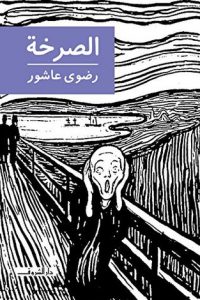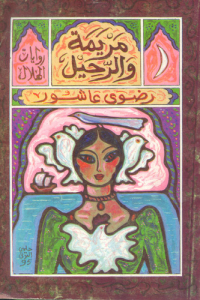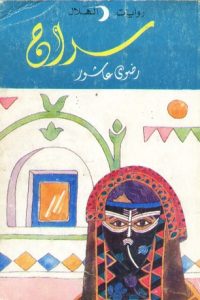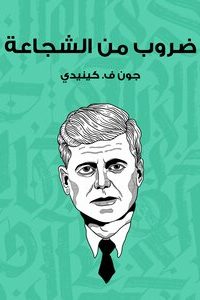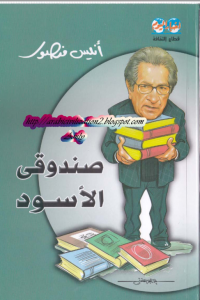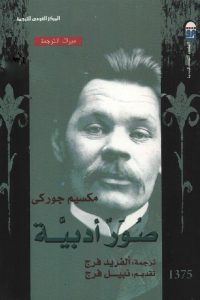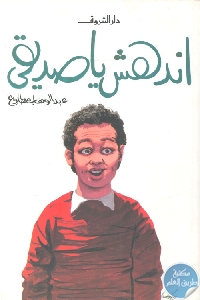تحميل وقراءة كتاب الرحلة: أيام طالبة مصرية في أميركا pdf مجاناً
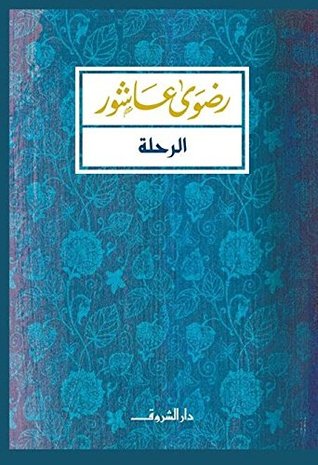
وصف الكتاب
غادرت القاهرة فجر30 اغسطس من عام 1973. قبلت مودعي ودخلت الى المنطقة الجمركية حاملة حقيبة يد صغيرة أودعتها جواز سفري المصري الأخضر وبطاقة الطائرة ومحفظة جلدية بها نقود وبضع صور عائلية. صورة صغيرة رسمها صلاح جاهين وصارت أغنية نردد فيها مع كورس الأطفال المصاحب للمغنى “صوره، صوره، صوره، /كلنا كده عاوزين صوره /صوره للشعب الفرحان /تحت الراية المنصورة!” ولما كان السؤال قائما –ساعتها كما الآن– ان كان من الممكن أن نجلس في هذا الجيل أمام الزمان لكي يلتقط لنا صورة تحت الراية المنصورة، فلقد أبقيت هذه الصورة المغناة جميلة ومصقولة مع تلك الأخرى التي استلمناها عقب حرب الأيام الستة، محروقة كأنها تعكس ما أصابنا من تفحم في الحريق.
ومع الصورتين احتفظت بصورة ثالثة، عائلية أيضا، يتصدرها ابي حاضرا وعنيدا، موزعا بين رغبته في أن يطلقني في الأرض امتداد لفورة حياة من صلبه ومخاوف مسلم ريفي الجذور يريد للبنت الستر، وأمي في الخليفة، واختي مقبلين، وأذا أتساءل.
ولم أكن أحمل معي صورة ذلك الشيخ المعمم ذي الوجه الوسيم، ولكن المؤكد أنه كان هناك في مكان ما من وعيي لو أنني توقفت لأدفق. كرفاعة كنت في طريقي الى بلاد “بعيدة عنا غاية الابتعاد” لتحصيل المعارف. ولكنني لم أكن مثله ذاهبة بحياد من لا يعرف شيئا مما هو مقبل عليه، ولا كنت مثل أجيال لحقته من مبعوثين راحوا وعادوا مدلهين في عشق الأنوار الإمبريالية.